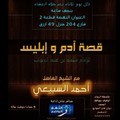بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، قال الإمام محمد بن عبدالوهاب-رحمه الله تعالى-، بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي موسى قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( إن الله خلق الله آدم من قبضةٍ قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والحسن والخبيث والطيب)).
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد...
فكنا قد تجاوزنا الكلام على هذا الحديث وشرعنا في الآيات، وها نحن نرجع إلى هذا الحديث ونتكلم على ما يسَّر الله-تبارك وتعالى- من المعاني التي تَضمَّنَها، وقد سبق وأن ذكرنا بعض الآحاديث عن النبيّ-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في معنى هذا الحديث أيضًا، الحديث يقول فيه النبيّ-صلى الله عليه وسلم-:((إن الله خلق آدم من قبضةٍ قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والحسن والخبيث والطيب))، الحديث طبعًا رواه عدد من الأئمه وصححه الإمام أحمد-رحمه الله تعالى- وأبو داوود والتّرمذي وابن حبان والألباني-رحمهم الله تعالى-.
والحديث فيه فوائد، فمن فوائدهِ بيان عِلمُ الله-جلّ وعلا-وحكمته وقدرته-تبارك وتعالى-، أمّا علمه-تبارك وتعالـى- فنحن نعلم أنّ الله-جلّ وعلا- بكل شيءٍ عليم-سبحانه وتعالى-، فعلمُ الله-جلّ وعلا- يتعلَّق بكل معلوم، فالله-تبارك وتعالى- يعلم ما كان وما يكون وما لو قُدِّرَ كُونه كيف يكون، أي أنّ علم الله-جلّ وعلا- يتعلق بالممكِنات والمستحيلات وكلُّ شئ -تبارك وتعالى-، فعلِم الربّ-تبارك وتعالى- أنّ آدم عليه-الصلاة والسلام – مَرجِعهُ إلى هذه الأرض، وإلاّ فإنّ الله-تبارك تعالى- في بادئ بِدءْ قدْ أكرمه بأن خلقه في الجنّه وجعله فيها، لكنّه رجع إلى الأرض كما هو معلومٌ من قصته-عليه الصلاة والسلام-.
فلمّا علم الربّ-جل وعلا- أنّ آدم راجعٌ إلى الأرض؛ كان خلقه من هذه الأرض حتى يناسب مقامه فيها إذا رجع إليها، كذلك في هذا الحديث حِكمَةُ الله-جلّ وعلا- البالغة، حِكمَةُ اللهِ-تبارك وتعالى- العظيمة-سبحانه وتعالى- فالله حكيم، ومن حِكمتهِ-جلّ وعلا- أنّه خلق آدم من الأرض بهذه الصفه، أنّه خلق آدم بهذه الصفه المذكوره في هذا الحديث، كذلك من حكمته أنّه خلق آدم من التراب لمناسبة عيشه بعد ذالك في هذه الأرض كما تقدم ذكره، ومن فوائد هذا الحديث أيضًا:
قدرةُ الله– تبارك وتعالى-البالغه حيث قبض الله-جلّ وعلا- قبضةً من الأرض كُلِّها، و قبضة الله-تبارك وتعالى-لا تقاس بقبضاتِ المخلوقين؛ بمعنى أنّ قبضة الربّ-جل وعلا- كلُ شيءٍ عنده بقدر، هي ليست قبضةً كما يقال عشوائية، إنّما هي قبضة يعلم قابضها-تبارك وتعالى- ما الذي سيأخذهُ بها.
كذلك في هذا الحديث إكرامُ آدم الكرامة الخاصة من بينِ سائِر مخلوقات الربِّ- تباركَ وتعالى- بأنّ خلقهُ بيدهِ- جلَّ وعلا- ولا شكَّ أنَّ هذه الكرامة العظيمة تنسحبُ فضلًا على ذريتهِ من بعده حينَ يعلمونَ أنَّ أباهم قد خُلقَ بيد الله جل وعلا- كذلك من الفوائد في هذا الحديث أنَّ الإنسانَ يعلمُ المبدأ، يعلمُ المبدأ واضحًا جليًا، فإذا علمهُ، عَلِمَ المبدأ فستجتمعُ همتهُ ويجتمعُ قلبهُ على المَعاد، كما نقول إنا للهِ وإنا إليهِ راجعون.
كذلك في هذا الحديث من الفوائد طمأنينة قلب المسلِم وراحته وهناءتهُ وراحة بالهِ، فهو يعلمُ ما أصلَ خِلقتهِ وكيف خُلِقَ وكل شيءٍ يتعلقُ بأمرهِ، فإنَّ هذا من العلم العظيم الذي يفتقرُ إليهِ أكثرُ النّاس الذين لا يؤمنون، فهم يعيشونَ في حيرةٍ وفي ضلال وفي هيام على وجوههم، لأنّهُ ليس عندهم نقطةَ إنطلاقة جامعة تجمعُ شتاتَ معلوماتهم وقلبهم في أصلِ وجودهم فضلًا عن أن يجمعوا همتهم بعد ذلك على توحيد ربهم- تباركَ وتعالى-.
فإذًا هذا الحديث يُطَمْئِن قلب المؤمن ويُبينُ لهُ حقيقة شمول وتفصيل بعثة النبيّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ((فَمَا من طَائِرٌ)) كما يقول أَبِو ذَرٍّ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأرضاه-: ((يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْسماءْ إِلَّا وَعندنا مِنْهُ خبر))، ما من شيء يحتاجهُ النّاس ويرتبطُ بمصلحتهم إلاّ وذكرهُ موجود، فكلُّ مسلم يعلمُ أنَّ أباهُ الأول هو آدم-عليهِ الصلاة والسلام-، وكلُ مُسلِم يعلمُ أنَّ آدم خلقهُ الله-جلَّ وعلا- بيدهِ، وكلُ مُسلِم يعلمُ أيضًا أنَّ آدم قد خُلِق من تُراب، تفصيل خِلْقَةِ آدم تكلمنا عن بعضها لما تطرقنا إلى ما جاءَ في الآياتِ من التُرابِ إلى آخره، إلى الحمئِ المسنون إلى الصلصال، حتى تفصيل ما خُلِقَ منهُ من التراب، وهذا حديث فيهِ من أيّ نوع من أنواع التراب خُلِقَ آدم-عليهِ الصلاة والسلام-، فخُلِقَ من كلّ الأرض لأنّهُ بعد ذلك سينتشر فيها جميعًا.
كذلك في هذا الحديث فيهِ؛ أنّهُ لا سبيلَ للمسلم أن يعرف الله-تبارك وتعالى- المعرفة الشرعيةَ الواجبة التي يقومُ عليها الإيمانُ بالله-تبارك وتعالى- إلاّ من جهة الوحي، ولذلك أوردَ الإمامُ ابن خُزيمة-رحمه الله تعالى- هذا الحديث في كتابه العظيم التوحيد، في بابِ إثبات اليدين لله-تبارك وتعالى-، حيثُ أنَّ الله-جلَّ وعلا- وصفَ يدهُ بالقبضة، مما يدلُ على أنّ ما جاء في القُرآن العزيز من وصفِ ربنا- تبارك وتعالى- باليد؛ أنَّ المقصود بذلك حقيقة الصفة لله-تبارك وتعالى-على ما يليقُ به.
إذًا فلا سبيلَ لمعرفة الغيب إلاّ عن طريق الربّ-جلَّ وعلا-، وهنا أيضًا فائدةٌ مهمةٌ جدًا، وأعتقد أنّها من الأهمية بمكان وأُحبُ أن ألفت النظر:
أنَّ هناك بعض الفوائد قد لا يعلم النّاس عِظم النفعِ بها وتكون سهلة التصديق والإيمان والتسليم، لكن من عَلِمَ مقالات القوم الضآلين وما وقعوا فيهِ من أنواع الضلالات، وزيغ القلوب عن الحقَّ، فإنَّ في بعض الحقّ الذي يعتقدهُ المسلِم قليلُ العلم من الخيرِ العظيم ما لا يُعرَفُ مداه، فينبغي لطالِب العلم وكلُ مُسلِم يجب أن يكونَ طالب علم بإعتبار، يجبُ أن يكونَ دَأَبهُ وهمتهُ الإنتفاع بالعلم فهذا أمرٌ مُهم، أن ينتفع بالعلم.
لأن المقصود بالعلم ماذا ؟
-أن يُنتَفع به، ولذلك النبيّ–صلى الله عليه وسلم- استعاذ من علمٍ لا يَنفع، فالمقصود من الفوائد المهمة أيضًا في باب الإيمان بالغيب؛ أننّا حين نقول الإيمان بالغيب؛ فالمقصود أنّ هذا الغيب هو بالنسبة لنا نحن غَيْب، لكنّه مثلًا بالنسبة للربّ–جل وعلا- كالشهادة:
﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [الأنعام: ٧٣]، ففي علم الله–تبارك وتعالى- يستوي الغيب والشهادة، فحين نقول إنّ هذا إيمانٌ بالغيب، فليس الموضوع أكثر من أنّه قد غُيّبَ عنّا نحن، لا أنّه يَفرِق عمَّا نعلمه من عالَم الشهادة، إلا ما علمنا بالدليل وبغير الدليل أنّه فارِقٌ بينه وبين عالِم الشهادة مثل الربّ–تبارك وتعالى- وأوصافه، فإنّها على ما يليق بالله –عزّ وجل-لا سبيل لإدراكِ كُنّها، ولا كيفيتها، لأنّ الله–تبارك وتعالى- لا يُحاطُ به علمًا، لأنّ الله–جلّ وعلا-: ﴿لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، لأن الله–جلّ وعلا-: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].
لكنّ الغيب بالنسبة لنا أمرٌ قد غُيّب، كما قال يُروى عن علي–رضي الله عنه-:"النّاسُ نِيام فإذا بُعِثوا ماذا؟ استيقظوا".
ولذلك مثلًا النبيّ–صلى الله عليه وسلم- مثلًا على سبيل المثال حتى نُقرّب هذا المعنى المهم، لأنّ لابد أن يُنفى عن الإيمان بالغيب أن يُظن به كأنّه مثل القضايا العقلية، أو الخيالية التي تَعلِق بالأذهان لا، الغيب وُجُود؛ خَلَقه الله–سبحانه وتعالى- لكن غُيّب عنّا نحن، لنقصنا ولمِحنة الربّ–جلّ وعلا- وابتلائِه حتى يرى من يؤمن بما أخَبَر من الغيب ومن لا يؤمن.
فمثلًا النبيّ–صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد أخبر أنّ الملائكة تحضر حِلَق الذّكر، كما في الأحاديث الكثيرة، فنحن مثلًا نرجو الله–تبارك وتعالى- أن يكون بحضرتنا من ملائكة الله –جلّ وعلا-، نرجو الله -عز وجل- أن يكون مجلسُنا مثلًا مُستَوجِبًا من جهة ربنا –جلّ وعلا- أن تكون ثمة ملائكة، فإذا وُجد الملائكة لا يستطيع المؤمن أن يراهم بعينه، لكن يحصل له من الأحوال ما ذكره النبيّ–صلى الله عليه وسلم- ما يعلم من طُمأنينةِ القلب، ولُمّتهم به، وتصديقهم، فضلًا عن انصراف الشياطين عنه بقُربهم منه، فيحصل للمؤمن فوائد، لكن هل هو يرى هؤلاء الملائكة ؟
-لا يراهم لأنّهم غُيّبوا لكنّهم موجودون.
ولذلك النبيّ–صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما جفلت إحدى الدواب مرةً من المرات، يعني اضطربت دابة اضطربت، فبيّن النبيّ–صلى الله عليه وسلم- أنّها تسمع ما لا تسمعون، وأنّكم لو تسمعون ما تسمع لما كذا وكذا، أو كما قال–صلى الله عليه وسلم-، فهنا هذه الدابة سمعت سمعًا حقيقيًّا لعويلِ من يُعذّب، وألمهم، وشعرت به شُعورًا حقيقيًّا، لكن هذا الأمر مُغيّب عن الإنسان، وهذه قُدرة الله الباهرة التي لا يُمكن للعقول أن تَقْرُب منها، غاية ما يُراد من العقول أن تُصدّق بخبر السماء، وأن تُسلّم لربّ المولى-سبحانه وتعالى-، وأن ترضى به ربًّا، وأن تُصدق بأخباره، هذا هو الإيمان بالغيب، هذا هو الإسلام.
حين يُخبرنا النبيّ–صلى الله عليه وآله وسلم- أنّ الدّيَكة تُؤذن حين ترى الملائكة، فإذا سمعنا نداءها شُرع لنا أن نذكر الله–تبارك وتعالى-، إذًا هي ترى شيئًا لا نراه نحن، وهذا النقص الذي؛ وهذا النقص الذي خلق الله–جلّ وعلا- عليه الإنسان؛ ليس هو في الحقيقة نقصٌ مُؤدٍّ إلى نقصِ منزلته، بل هذا النقص هو سر أحد أسرار كماله، لماذا ؟
- لأنّه سيؤمن بما يخبرهُ به الله–عزّ وجل- فيْكمُلُ ويزدادُ إيمانًا، ويرضى عنه الله–جلّ وعلا-، إذًا فالإيمان بالغيب هذا هو معناه، فليُنْتَبه إلى ذلك.
كذلك من الفوائد التي تتعلق بهذا الحديث العظيم؛ أنّ معرفة المبدأ أمر غاية في الأهمية من جهة أنّ كلّ العلوم التي تترتب بعد ذلك؛ ستترتب على هذا الأمر، لأنّ الإنسان إذا علم شيئًا تتطلَّب ما ورائه، ويستقر قلبه عليه، ولذلك أنت تجد أنّ الملاحدة، والمنافقين، وغُلاةُ أهل البدع؛ دائمًا تتجه سهام عقولهم إلى التشكيك في أصل المبدأ، لماذا؟
لأنّهم يعلمون أنّهم إذا كسروا هذا العِلم؛ فإنّ المسلم سينفتح قلبه على الأهواء على مصراعيه، بينما المسلم يعلم المبدأ بإخبار الله–تبارك وتعالى- كما رأينا في هذا الحديث.
كذلك من الحكم العظيمة في هذا الحديث أيضًا، أن الله –تبارك وتعالى- خلق الإنسان من الأرض كلّها، فجاء بنو آدم–عليه الصلاة والسلام- ألوانهم، وصفاتهم، وأبوهم واحد، لكن تنوعت صفاتهم وألوانهم، فهذا فيه آية من آيات الله–تبارك وتعالى-، كما قال الله –جلّ وعلا-:(( وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ))]الروم: ٢٢[، فهذه من آيات الله –تبارك وتعالى-.
كذلك مما في هذا الحديث؛ أنّ النّاس يرثون صفات الأرض التي خُلِقُوا منها حَسنُهَا وقَبيحُها، أمّا إّرثُهم لحَسَنِها فواضح، يوضحه مثلًا ما يأتي من الصفات التي تكون في الجبلة، يعني في أصل الخلقة، الإنسان يكون عنده صفات حسنة يرزقها الله –جل وعلا- إياها، كما تعرفون جميعًا في الحديث العظيم المشهور: ((لما تخلّف ذلكم الرجل عن الركب الوفد؛ الذين جاءوا للنبيّ –صلى الله عليه وسلم- فتوافدوا، ودخلوا عليه، فتأخّر عنهم، يقوم بربط أمتعتهم، وربط دوابهم، وما أشبه ذلك، حتى جاء إلى النبيّ–صلى الله عليه وسلم- فقال له: إن فيك صفتان يحبهما الله ورسوله، الحِلم والأناة،(انظر إلى عقل ذلكم الرجل –رضي الله عنهم وأرضاهم-، أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم-)، قال له: أفيَّ هم أم جُبلت ؟ (أتَخَلّقتُ بهما، أم جُبلت عليهما؟ أو ما معناه) قال: بل جُبلتَ عليهما، قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب)).
فعلم الفرق بين الصفات التي تكون في الإنسان أصلًا؛ وبين الصفات التي يكتسبها، وسأل عن ذلك، فأراد أن يعلم هل هو مما اكتسبه بجهاده لنفسه، صار فيه هذه الصفة، من الحلم والأناة، وِلاّ شيء الله–عزّ وجل- أكرمه به.
فأخبره النبيّ–صلى الله عليه وسلم- إنّ هذه كرامة من الله لك، فعَرف وعلِمَ الواجب تِجاه نعم الله –تبارك وتعالى- وهو شكره –سبحانه وتعالى- على نعمته وفضله –جلّ وعلا-.
طيب، من لم يُجبَلْ على الصفة الحسنة، فمُنع مقتضاها، فصار إلى ما صار إليه، مما عُدِمه، من الصفة الغير حسنة، فهل هذا شؤمٌ، وبلاءٌ عليه، وشرٌّ عليه ؟
في الحقيقة أنّه يكون شرٌّ عليه وبلاءٌ عليه، إذا رضي وسكت وترك نفسه على أصل ما هو عليه؛ دون أن يجاهدها بالعلم والعمل ويطهِّرها ويزكِّيها، فهنا نعم، يكون شر عليه.
- حتى الأول إن لم يؤمن ويتقِّ، ولم يشكر الله–عزّ وجل– على نعمته أيضًا؛ يكون ذلك شر عليه، ولكن إذا جاهد نفسه وجاهد الصفة السيئة من نفسه حتى يغيرها لله–تبارك وتعالى-، فإنّ هذا يُوجِب من الأجور، ويُوجِب من القرب إلى الله –تبارك وتعالى- أيضًا نوع وشيء من عبادة الله –عز وجل-.
فالحمد لله-تبارك وتعالى- أنّ العبد الذي يتقيهِ أيًا كان حاله فهو على خير، هذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث.
وفي الحقيقة أحبُّ أن أستطرد إلى مسألة أجدها مهمة تقريرها في هذا السياق، أو بما له علاقة فيما ذكرنا، طبعًا هذه المسألة تتعلق بماذا ؟
-أنّنا نحن في وقت وزمن هذه الأزمنة لاشك أن الله –تبارك وتعالى – قد فتح من مكنونات الأرض، ومن العلوم الجديدة المستحدثة وممّا يسمّى بالاكتشافات شيء تكاد تتسارع فيه الدقائق فضلًا عن السنين، حتى بلغ بالإنسان ما لا يخفاكم أن وصل إلى المريخ وأن يحط رِحاله عليه، يختبر أرضه إلى غير ذلك من أنواع المكتشفات التي سلبت عقول النّاس وأبهرتهم، هذا أمر واقع وموجود وهو وجود هذه المكتشفات والعلوم التي فتح الله-جلّ وعلا- في هذه القرون المتأخرة بحكمته-سبحانه-، فهنا حُكم هذه الأمور أعني تَطَّلُب هذه المكتشفات؛ فهذا الأصل فيه الإباحة .
كذلك المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الموضوع:
هو أنّه لا يمكن أن يكون ثمة شيء مما يُفْتح من هذه العلوم، ويَثْبُت ثم يكون فيه أي نوع من المعارضة لما بُعِث به النبيّ-صلى الله عليه وسلم-، فهذا من المستحيلات أبدًا، لا يمكن أن يكتشف الإنسان شيئًا في الوجود اكتشافًا ثابتًا ثمّ يكون فيه بأي حال من الأحوال معارضة لما بُعِث فيه النبيّ–صلى الله عليه وسلم-.
المسألة الثالثة أن واجب أهل العلم:
واجب أهل العلم؛ سواءٌ كانوا يشتغلون بتدبر القرآن، والعناية بمعانيه، أو بغير ذلك من أنواع التفقّه في الدين، وفي كلام النبيّ–صلى الله عليه وسلم-، واجبهم الشرعي هو أنهّم لا يتطلَّبون هذه المكتشفات والأشياء ويتتبَّعونها !
فإنّ هذا ليس من مهمتهم، وليس هذا من عملهم، وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن هدي السلف الصالح.
المسألة الرابعة:
أنّ من كانت مهنته أو محبته أو عنايته بمثل هذه العلوم أيًا كانت؛ فلا ينبغي عليه إذا كان مسلمًا أن يلفِتَ النظر دائمًا إلى الربط بين ذلك وبين الدّين، فإنمّا هو فيه إنمّا هو من متاع الحياة الدنيا التي جُبِلَ النّاس على تَطلُّبها.
فلا يظنّ أنّه فيما هو فيه؛ أنّه قائم بالتفقّهِ في الدّين، أو أنّه يلصق ما هو فيه ويرجعه إلى الدّين، فإن هذا لا يجوز له.
المسألة التي تلي ذلك:
أنّ تَطّلُب العالم أو طالب العلم؛ أنّ يفسِّر الدّين بمثل هذه المكتشفات والمخترعات هو من البدع المحدثة التي لم تكن في زمن السلف الصالح وحسبه أن يعلم، حسبه أن يعلم أنّه خارج عن هدي الصحابة والنبيّ–صلى الله عليه وسلم- والتابعين، فالمتفقّه في الدّين الله-جلّ وعلا-يقول: }كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ{ ]ص: ٢٩[،
فما الذي أن يُتَدبَّر ؟
-آيات الله – جَلَّ وعَلا-، تُتَدَبَّر كَيف؟ مِن جِهَة كَلامِ الله، مِن جِهَة كَلام الرَّسول– صلى الله عليه وسلم -، مِن جِهَة كَلام التّابِعين، ثُمَّ في النِّهايَة مِن جِهَة اللُّغَة، أَمّا غَيْرَ ذلِك فَإِنَّهُ أَجْنَبِيّ عَنِ الدّين، فالّذي يُدخِلُ الفقْهَ في الدّين في ذلِك؛ هذا نَوْعٌ مِنَ الإِحداث، وكَذلِكَ أَيْضًا المُشْتَغِلُ بِمِثْلِ هذِهِ العُلوم مِمَّن يتطَلَّبُ مُعارضة ما بُعِثَ بِهِ النبيّ– صلى الله عليه وسلم–، سواءٌ قَصد إِلى هذهِ المُعارضة قَصْدًا أَو أَنَّهُ وَقَعَ فيها عَرَضًا؛ فَإِنَّهُ واقِعٌ في أَمْرٍ مُحَرَّم لا يَجوزُ لَهُ، مَرْتَبَتُهُ في الحُرْمَة بِحَسَبِ قَصْدِهِ وحالِه؛ لِأَنَّ بَعْض مَن يُسْلِم مِنَ الكُفّار على أَيْدي أَهل البِدَع قَدْ يَجِدُ في بَعْضِ الأَحاديث مَثَلًا مَعْنى لا يَسْتَقيمُ على قَوانينِ العِلم المَوْجود، فَيَقولُ لَهُ أَهلُ البِدَع:
أَنَّ هذِهِ الأَحاديث آحاد لا يَجِبُ عَلَيكَ أَن تَأْخُذَ بِها مَثَلًا، فَيوقِعوهُ في حُفْرَةِ رَدّ الأَحاديث بِبِدَعِهِم، مِثْلَما حَصَلَ لِرَجُل اسمُهُ (مُريس بوكايْن) قَدْ أَسْلَم فَرَدّ بَعْض أَحاديث النبيّ– صلى الله عليه وسلم-، وَأَلَّفَ كِتابًا في القُرآن ورَدَّ بَعْض الأَحاديث، لِظَنِّهِ أَنها تَتَنافى مَع ما جاءَ في العِلم، لكِنّنا نَرجو أَن لا يكونَ ذلِكَ مِنْهُ كُفْر بِالله– تَبارَكَ وتعالى-.
وَكَما قُلْت فَتَتَبُّع مِثْل هذِهِ العُلوم لِتَفْسيرِ الدّين بِها، هذا مِنَ البِدَع المُحْدَثَة، وكذلِك فَإِنَّهُ يَفْتَح على النَّفْس وعلى الإِنسان القَوْل على الله بِغَيْر عِلْم، وَأيضًا قَد يوقِعهُ لِأَنَّ ما أَخْبَرَ الله – جَلَّ وعَلا– بِهِ خَبَرٌ صادِق لا مَحالَة، لكن ما يُكْتَشَف قَدْ يُكْتَشَفُ مِنْهُ جانِب أَو في وَقْت أَو في نَقْص، إِذا كانَ بَعْضُ العُلَماء، عُلماء الدّين؛ عُلَماء الدّين المَأْمونين النّاصِحين الكِبار، لَمّا جاءَ إِلى قَوْلِ النبيّ– صلى الله عَلَيْهِ وسَلّم – في الحَديث الّذي في صَحيح البُخاري، لمّا ذَكَر النبيّ– صلى الله عليه وسلم –: ((أَنَّ الله - جَلَّ وعَلا - لمّا خَلَقَ آدَم خَلَقَهُ طولُهُ سِتّونَ ذِراعًا في السَّماء))، ثم قال – صلى الله عليه وسلم -: ((ولا يَزالُ الخَلْق يَتَناقَص، حَتّى إِذا كانَ يَوْمُ القِيامة عادَ بَنو آدَمَ على هيْئَةِ أَبيهِم الأولى)) طَيِّب، هذا العالِم نَظَر في هذا الحَديث، ثُمَّ كانَ قَد وَقَفَ على شيءٍ مِنَ الآثار القَديمَة جِدًّا، فَرَأى في هذِهِ الآثار أَنَّ هَيئَةَ النّاس، وَصِفَتُهُم لا تَبْعُدُ كَثيرًا في الطّولِ عَمّا هُوَ عَليْه، فاسْتَشْكَلَ أَنَّهُ لَوْ كانَ الخَلْقُ يَتَناقَص؛ لَكانَ يَنْبَغي أَن يَكونَ هؤلاءِ وآثارُهُم قَبْلَ آلافِ السِّنين على طولٍ أَكْثَرَ مِمّا رَأَيْتُهُ، فاسْتَشْكَلَ هذا الأَمْر وبَيَّنَ اسْتِشْكالَهُ – رَحِمَهُ الله -، فَأَقول: إِذا كانَ عالِم قَصْدُهُ حَسَن، مُتَفَقِّهًا في الدّين، مُجَرَّد أَنْ جَرى عَقْلَهُ في المُقارَنَة؛ وَقَعَ في هذا الاسْتِشْكال، فَكَيْفَ بِمَن دونَهُ مَع عَدَمِ كمالِ المَقاصِدِ والعُلوم والإِرادَة، وَأَن يَكونَ المُقارَنة شُبَهًا تُقْذَفُ وتُلْقى!!!
فَكَم يَفْتَح المُسْلِم على نَفْسِهِ، وعلى قَلْبِه مِن أَبْواب الضَّلال مِن حَيْث أَنَّهُ يَظُن أَنَّهُ مُحْسِن، كَذلِكَ فَإِنَّ ما يُكْتَشَف أَو ما يُعْلَمُ حُصولُهُ مِن هذِهِ الأَشْياء أَيًّا كانَت في أَيِّ بابٍ مِنَ الأَبواب، فَهِيَ مِن جِهَة تَكونُ فيها زِيادَةُ إيمان، ويَكونُ فيها مِن مَعْنى قولِ اللهِ– تَبارَكَ
وتعالى-: }سَنُريهِم آياتِنا في الآفاق وفي أَنْفُسِهِم حَتّى يَتَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُ الحَق{[فصلت:53].
إذنًا: هي يحصُل فيها لكن هذه الآيات أولًا:
-هي تُرى للنّاس، بمعنى أنّهم غير مطلوب منهُم تقصُّدُها.
-الأمر الثاني: أنّ هذه الآيات ما هي مُختصّة بالمكتشفات والمخترعات أو شيء مُعيّن، الإنسان يرى في نفسهِ، يرى في الوجود يرى أشياء فيتّعِذ ويعتبِر، فليس الأمرُ مُختصًا بذلك لكن حُصول الفائدة ببعضِ هذه الأشياء قدْ يحصُل.
طيب ما هو حُكم ذكرُ بعض مثل هذه الأشياء ؟
-إذا كان ذكرُها نافعًا في مقامٍ ما؛ دون أن يكون ذلك لصيقًا بالدّين وتفسيرًا له فإنّ هذا لا مانع منه، من جهة التتمّة والتبع، أو من جهة الطرافة كما مثلًا ذكر البخاري –رحمه الله تعالى- عن ميمون بن مهران قصة القردة التي زنت فرجمها قومها، قصة زنت فماذا حصل من سائر القردة ؟
- أنّهم رجموها وكان ذلك مما رآه في الجاهلية فذكره البخاري، فالطُرَفْ والمِلَحْ والأشياء التي، هذا لا مانع منه وقد يحصل منها فائدة.
لكن أن تكون أصل أو أن يُشغل النّاس بها وما أشبه ذلك؛ على الطريقة التي تجري فإنّ هذا فيه مجازفة عظيمة من جهة الدّين، لكن لو علِم المسلم شيئًا من ذلك فلفت نظره إلى معنى فهذا طيب، ما فيه مانع من حيث الأصل.
مثلًا إذا ذكروا؛ مثلًا أنّ الغربان حين تتبعوا طبائعها، فرأوا فيها من الحقد والكراهية أنّها تنتقم وتسعى في الأذية، فهذا نحن قد أُغنينا عنه بما أخبرنا النبيّ–صلى الله عليه وسلم- من وصف الغراب بالفسق، أصلًا، هم الآن يكتشفون هذا الأمر هنيئًا لكم، نحن خبّرنا رسولنا –صلى الله عليه وسلم-هذا الأمر، لكن لو اكتُشف مثل هذا وصدّق فهنا مثل هذا ايش؟
- ما في بأس يعني شيء من الطُرفة، أو أحيانًا قد يذكر بعض أهل العلم كما صنع مثلًا الإمام ابن القيم–رحمه الله تعالى- في "شفاء العليل"؛ قد يُذكر أشياء من طبائع الحيوان أو من طُرفه أو من تعاون أصنافه مختلفة، كذكره مثلًا أنّ ثعبان أعمى كانت تأتيه حمامة بطعامه، أو ما أشبه ذلك.
فإنّ مقصود أهل العلم في ذكر مثل هذه الأشياء الرد على الطبَائِعيِّن والدَهريِّن، والردّ على من ينفون الأسباب والعلل وحِكم الله-تبارك وتعالى-، فمثل هذا المقام يُستأنسُ بأشياء لا بأس من ذلك، هذا جرى عليه عمله أهل العلم تذكيرًا بمثل هذا الشيء الذي ينفي ما يذكره بعض النّاس من نفي حكمة الله–تبارك وتعالى-، أو نفي الأسباب أو ما أشبه ذلك.
كذلك مما يتعلق بهذا الباب: أنّ غاية هذه المكتشفات والاستدلالات غايتها ماذا ؟
-غايتها أن تزيد في الإيمان بربوبية الله–تبارك وتعالى-، إذًا هي صابَّة في ماذا ؟
-في توحيد الربوبية، لكن توحيد الأسماء والصفات؛ معرفة الله–جلّ وعلا-، توحيد القصد والطلب؛ إخلاص الدّين لله –عزّ وجل-، فهذه الأشياء ليست هادية في هذه الأبواب، إنّما الهادي في ذلك والمقرِّرِ له؛ هو كلام الله وكلام الرسول–صلى الله عليه وسلم-.
إذًا فما فيها من فائدة مرجوة فهي صابّة في جزءٍ معين، أمّا من جهة الأصل الذي بُعث به النبيّ–صلى الله عليه وسلم- معرفة الله –جلّ وعلا- وتوحيده وإخلاص الدّين له–تبارك وتعالى-، فإنّه لا يُنالُ من هذه الجهة وهذه الحيفّية.
وهنا أحبُّ أن أُنبه تنبيهًا مهمًا عامًا لكل مسلم ومسلمة؛ أنّه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يُفرق بين مقامين يخْلِطُ النّاس في هذا الزمن بينهما كثيرًا:
ألا وهو مقام الإنتفاع ومقام الإستمتاع إذا صح التعبير، أنا اختار هذه اللفظة لتقريب المعنى، عندك انتفاع وعندك ماذا ؟ استمتاع، فيجب على المسلم أن يحرص في أمر الدّين على ما ينفعه، يقول النبيّ–صلى الله عليه وسلم-: ((احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ))، إذا كان في أمور الدنيا، فكيف بأمور الدين!
فيحرص الإنسان على العلم النافع الموروث عن النبيّ–صلى الله عليه وسلم-، وعن الصحابة وعن التابعين، يحرص على المنفعة الدّينية، لا يحرص على ما يُمْتِعُهُ وما يجعله ينسجم مع المتكلم، فإنّ هذا من أسباب الفتن التي كثُرت في هذا الزمن، فيجب على المسلم أن يكون صاحب قرارٍ حازم، وصاحب قوة ويقين، فيُفرِّق بين الأشياء أمر الدّين؛ أدخِلْهُ بجدّية،
وبصدق، وبحرص، وبتمسُكٍ صادق، النبيّ–صلى الله عليه وسلم- يقول: ((عضّوا عليها بالنواجذ))، لكثرة ما يصرِفُ عن الحقّ ممّا يحتاج إلى صبر وجهاد، والمسلم اليوم إذا سمع شيئًا يتطلب ما يُطرِفه، وما يستغربه ثمّ يجعل نفسه عرضةً لأهل البدع والأهواء!!!
فإنّ هذا يُلحق بالمسلم الضرر من حيث لا يشعُر.
كذلك مما يتعلق بهذا الأمر أنّه ليس من وظيفة القرآن التي أنزل الله–تبارك وتعالى- القرآن من أجلها علوم الدّنيا، هذا ليس من وظيفة القرآن، فحمل مثل هذه الأشياء عليه؛ يوقع في تحريف القرآن، وهذا كثير في هذه الأزمنة، وما ذكرته في هذا الباب، خلاصة معنى ما تقدم في الحقيقة، قد ذكره علماؤنا –رحمهم الله تعالى-، فللشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان؛ فتاوى في هذا الباب، تُبيّن إنكارهم ما يسمّى بالإعجاز العلمي للقرآن.
وهذه الأشياء على النحو الذي حصل من قِبَلِ بعض النّاس.
وأقول إن ما يحصل اليوم من هذا الإسراف، ومن هذه الأبواب بهذه الطرق المبتدعة؛ في الحقيقة، يعني حسْبُك أنّه ثمرة للدعوات العصرانية المبتدعة، دعوات الجماعات الإسلامية السياسية.
يعني هذه من ثمارُهم في هذا الزمن، تعريضهم كلام الله –جلّ وعلا- لِأن يُحَرَّف، من أجل ماذا ؟
أن يعيشوا العصر ويتتبَّعوا الواقع، وأن يُظهِروا أنّه مختلفين عن الدّين العتيق، وما كان عليه العلماء! وهذا أمرٌ منكر، يدلُّ على أنّه ينبغي الإنتباه إلى ذلك.
والعجيب أنّ كثير ممن يتصدى لمثل هذه الأشياء العلمية؛ في الحقيقة أنّهم يوقعون النّاس في البدع الأخرى!
الآن مثلًا: سمعت لبعضهم في هذه الأبواب يتكلم، ثمّ يصف القرآن الذي هو بصدد أن يُبين إعجازه، فيقول: انظر إلى هذه الحروف المخلوقة!
هو عقيدته ماذا؟ عقيدته فاسدة، من أعظم المعارك التي وقعت بين أهل السنّة وأهل البدعة؛ مسألة القرآن، وأنّ القرآن كلام الله –تبارك وتعالى- غير مخلوق، وهذا يعتقد أن القرآن مخلوق!
فإذًا فاقد الشيء لا يعطيه، هو بحاجة إلى من يُصْرحه، كذلك ما يخفاكم مثلًا هذا المشهور؛ الذي شُهِرَ واشتهر بتتبُّع مثل هذه الأشياء من الثمانينيات، أعني المسمّى بالزنداني، فقد رأينا حين جاءت هذه الثورات؛ أنّه أتى بحديث الرسول–صلى الله عليه وسلم-، حديث سفينة مولى النبيّ–صلى الله عليه وسلم-، الذي يذكر فيه النبيّ–صلى الله عليه وسلم- تدرج الخلافة والملك في أمّة النبيّ–صلى الله عليه وسلم-، ثم يذكر آخره: ثمّ تعود خلافة راشدة، ويبشِّر أنّ ما يجري من هذه الثورات، وما تبشر به من هذه الدول التي ستقوم، أنّها عودة للخلافة الراشدة!!!
أيُّ تحريفٍ لكلام النبيّ–صلى الله عليه وسلم- أعظم من هذا !
أَيُّ تحريفٍ لدينِ الله –جلَّ وعَلا- أَشدَّ من ذلك، فما الذي نَفعه من تَتَبُع هذه المُكتشفات؛ والجنين في بَطن أُمه وأطواره !!! وقال فُلان وفُلان، ما الذي نَفعه ؟
فهذا يدلُّ على أنّ تتبُع مثل هذه الأشياء لا يُعطي المسلم العلم النافع الذي يهديه، ويُحصِّنه من البدع والأهواء!
كذلك مما أُحِب أن أَذكُره وأُنكره بشدَّة: أيضًا تفسير ما يجري اليوم في يوم القيامة ببعض النظريات والأشياء، من جهة بعض العلوم، أنّه سيكون ارتطام بين الكواكب، وأنّ هذا الإرتطام سوف! ثم يُفسّر بذلك ماذا؟
ما يجري في يوم القيامة ! فإنّ هذا أمرٌ خطير، هذا أمرٌ خطير وحُكمه عند الله –جلَّ وعلا- كبير، بل قد يصحُّ أن أقول:}وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّـهِ عَظِيمٌ{ [النور: 15].
النبيّ–صلى الله عليه وسلم- لما مُطِرَ النّاس فأصبح النّاس يتحدثون، لأنّ هناك أنواء ونجوم وأسباب خلقها الله–جلَّ وعلا-، ومن طبيعة الإنسان أنّه يَجمع العلوم والملاحظات، يجمعُها يجمعُها يجمعُها حتى يكون عنده علوم واضحة في الأشياء في الرَّبط بينها، فالمقصود قال النبيّ–صلى الله عليه وسلم- على إِثر ليلة مَطيرة قال: ((يَقولُ الله –جلَّ وعلا- أَصْبَحَ مِنْ عِبادي مُؤمِنٌ بي؛ كافِرٌ بِالكَوكَب، وأصبح من عبادي مؤمنٌ بالكوكبِ؛ كافرٌ بي)) فقال النبيّ–صلى الله عليه وسلم-: فسّرها، فسّرها الرسول–صلى الله عليه وسلم-فقال: ((من قال مُطرنا بِنَوْءِ كَذا وَكَذا، فَهُوَ كافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَب، ومَن قال مُطِرْنا بِفَضلِ الله وَرَحْمَتِه، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بي كافِرٌ بِالكَوْكَب)).
فكذلك ما يُخبر الله–جلَّ وعلا- به يوم القيامة بتفصيل، عظيم، كثير من تسمية يوم القيامة بأسماءٍ شتى في القرآن العزيز، ومن ذِكر ما يجري من زلزلة الأرض:}وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ{[النمل: ٨٨]، إلى غير ذلك من أوصاف القرآن، فهذه ينبغي أن تُتلقى من جهة القرآن وحده، ومن فسّرها بمثل هذه الأسباب فإنّه لا يَقل جُرمًا على من لَفت النظر إلى الأسباب بعد الليلةِ المطيرة! وإنّ هذا أمرٌ خطير، والأخطر منه أنّك تجد بعض الكاتبين في العقيدة يجعل في حاشيته نُقُول عن بعض الكفار؛ وعلمائهم في الفلك أو ما أشبه ذلك، وأكثرها نظريات وليست بحقائق أصلًا، يَنقل عنهم كلامًا فيه تفسير يوم القيامة بما سيجري من مثل هذه الأسباب، حاشية الأسْعَوِي، وهذا يَزعُم السنّة، ويزعم خدمة كتب السنّة، ودبّت إليه هذه المادة من جهة ماذا؟
-من جهة استسلامه لبدع الجماعات الإسلامية، التي تدعو الإنسان لأن يعيش بالعصر كما يعيشهُ أهل العصر، فيتأثَّرون أكثر مما يُؤثِّرون، ويحصل بهم من الضرر الشيء العظيم، وهذا أمر خطير!
فالذي ينبغي في التفقّه في دين الله–تبارك وتعالى- أن يُعوَّلَ على كلام الله، وعلى كلام النبيّ–صلى الله عليه وسلم-، وعلى كلام الصحابة، على ما كان عليه الناس سابقًا، وهذه الأمور التي فُتِحَت يُنتفَعُ بها، لكن ليس للدّين شأنٌ فيها من جهة تطلُّبِها، وليس الدّين بحاجةٍ إلى أيِّ شيئٍ منها، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.