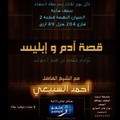الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلهِ وَسَلَم، قالَ الإمام محمد بن عبدالوهاب- رحمهُ الله تعالى-وقولهُ تعالى:{ فَإِذَا سَوَّيْته وَنَفَخْت فِيهِ مِنْ رُوحِي}، فذكروا له أربع خصائص:
- فالمنفوخ منه الروح المضافة إلى الله إضافة تخصيص وتشريف، والله هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح، وهذا الذي دلّ عليه النص. وأمّا كون النفخة مباشرة منه- سبحانه كما خلقه بيده أو أنها بأمره كقوله في مريم :}فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا ] {الأنبياء:91[، مع قوله:
}فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا] {مريم:17[، إلى آخره فهذا يحتاج إلى دليل، فإنّه أضاف النفخ إلى مريم لكونه بأمرهِ، وإلي الملَك لكونه المبَاشر للنفخ.
وفي القصّة فوائدُ عظيمة وعبرٌ لمنِ اعتبر بها.
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلهِ وسلم، أما بَعْد،
فحتى يتسنّى لنا حُسنُ فهم كلام الإمام- رحمهُ الله- هنا وبعُمق، ومن حيث أنَّ فهم هذا الكلام لهُ نظائِر كثيرة، يُحتاج إلى معرفةِ ما تُبنى عليه حتى يصطحب المسلم في فهمهِ ما يُحتاج إليهِ في المواضِع المُتشابهة، فأقول لابُدّ لنا من الكلامِ في مسألتين بينَ صدر كلام المصنّف- رحمهُ الله تعالى- هنا، هاتان المسألتان هما مسألة يعني أنا أُطلِقُ عليها مسألةُ التفضيل، والمسألةُ الثانية يُطلقُ عليها أهلُ العلِم مسألةُ الإضافة، أي ما يُضافُ إلى الله- تباركَ وتعالى- يعني ما يُوصَفُ بهِ الله أو يُضافُ إليهِ، مما هو ليسَ صفةً لهُ ففيما يتعلقُ بالمسألةِ الأولى؛ مسألةُ التفضيل والمقصودُ بالتفضيلِ هنا:
- أي تفضيلُ الله- تباركَ وتعالى- لبعضِ مخلوقاتهِ أو ما يُفضّلهُ اللهُ- تباركَ وتعالى- مما يكونُ أقربُ إليهِ أو يُقَرِّبُ إليهِ، أي الأعمال الفاضلة التي تُقرِّبُ إلى الله-جلَّ وعلا-.
فنحنُ نعلم أنَّ الفضلَ كلهُ بيد الله- تبارك وتعالى- ، واللهُ- جلَّ وعلا-من حِكمتهِ أنّهُ يُفضّلُ بعض الأشياء على بعض وهذا من تمامِ قُدرتهِ وحكمتهِ- سبحانهُ وتعالى-، في بعضِ مخلوقاتهِ يُفضّلُ بعضها على بعض كما قالَ الله- جلَّ وعلا- مثلًا في بعضِ أنواع الطعام {وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ} [ الرعد:4]، مع العلِم أنّها تُسقى من ماءٍ واحد حتى يُرِيَّ الناسَ فائِقَ قُدرتهِ-جلَّ وعلا- ، كذلك اللهُ- جلَّ وعلا- مثلًا يُفضلُ أنبياءه، الأنبياء هم أفضلُ البشر عند الله- جلَّ وعلا-، أفضلُ البشر عند الله-جلَّ وعلا- هُم أنبياءُ الله سبحانهُ وتعالى، ومع هذا يقول ربّنا-تبارك وتعالى-: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ}[ البقرة 253].
إذًا النقطة المهمة هنا أو المسألة المهمة التي يجب أن ينتبه لها المسلم، إذا انتبه لها المسلِم، وعقلها واعتقدها وأحسن فهمها؛ فإنّهُ يُفْتَحُ لهُ بابُ خير عظيم، ويُصدُّ عن أبوابَ شرورٍ عظيمة، وهو أنَّ الفضلَ والتفضيل إنما مصدرهُ ويؤخذ من الله- جلَّ وعلا- وحدهُ، الفضلُ والتفضيل يؤخذُ من الله – جلَّ وعلا-.
فإذًا: إذا أردتَ أن تعرفَ فضلَ إنسانٍ ما؛ أو أردتَ أن تعرفَ فضلَ فعلٍ ما، أو قولٍ ما، يجب أن تُرجعهُ للمصدر الذي نعرِفُ فيه فضل الأشياء وتفاضُلها؛ وهو كلامُ الله وكلام رسوله–صلى الله عليه وسلم، ليس لنا سبيل إلّا ذلك، فالله–جلّ وعلا- يُفَضِّلُ بعضَ الأعيان؛ يعني الله –جل وعلا- مثلًا فَضَّلَ الأنبياء على غيرِهم، فَضَّل الله –تبارك وتعالى- أصحابَ نبيِّهِ–صلى الله عليه وآلهِ وسلّم-، وهذا كثير في القرآن وفي كلامِ النبيّ–صلى الله عليه وسلم-، يُفَضِّلُ الله–تبارك وتعالى- أحيانًا تفضيلًا عامًّا يَشْمَلُ قوم كثيرون، وأحيانًا يذكُرُ فضائلَ خاصّة لأعيانٍ معيّنة وأشخاصٍ معيّنين؛ فمثلًا قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: ((خيرُ النّاس قَرْني، ثمَّ الذين يَلونَهُم))، هذا تَفضيل عام؛ لمن؟
للصّحابة والتابعين وأتباعِهِم بإحسان، ثمّ قد يَأتي في الأدلّة تَخصيص بعض أصحاب النبيّ–صلى الله عليه وسلم- بفضْلٍ خاص، أو قد يأتي في الأدلّة تفضيل بعض الأنبياء بصِفاتٍ خاصّة، وكذلك طبعًا: تفضيل الأعيان (أعني) أعيان الأشخاص يعني مثل: ما قال النبيّ–صلى الله عليه وسلم- مثلًا: ((كَمُلَ مِنَ الرِّجالِ كثير، ولَمْ يَكْمُل مِنَ النّساء إلّا أَرْبَع))، إذًا هذه النُسْوَة الأَرْبَع فُضِّلْنَ على غيرِهِنَّ من النساء؛ كما قال–صلى الله عليه وآلِهِ وسلم-: ((فَضْلُ عائِشَة على النِّساءِ؛ كَفَضْلِ الثَّريدِ على سائِرِ الطَّعام))، وهكذا؛ ولذلك يَحْرِص الأئمّة –رحمهم الله تعالى- يَحْرِصونَ تمامَ الحِرْص على أنَّهُم يَذْكُرونَ الفضائِل؛ فضائِلِ البِقاع، فضائِلِ الأشخاص، فضائِل المُعيَّنة، لماذا ؟ لأنّهُ ليس هُناكَ طريق لمعرِفةِ فضل معيّن إلّا عن طريقِ الوحي وما جاء عن الله-تبارك وتعالى-.
بعد انْقِضاءِ عصرِ الصحابة –رضوان الله عليهم- والتابعين وتابِعيهِم بإحسان؛ يعني مثلًا النبي –صلى الله عليه وسلم- ذَكَرَ رجلًا واحدًا من التّابِعين، ذَكَرُهُ بِخِصّيصَة وبِفضِل خاص، قال: ((سَيِّدُ التّابِعين أُوَيْس)) كما في مُسلم، فهنا هذا فضل خاص، ذَكَرَ النبيّ–صلى الله عليه وسلم- لرجلٍ يأتي من بعدِه؛ كما ذكر مثلًا النبيّ–صلى الله عليه وسلم- مثلًا ما يكون من شَأْنِ المَهْدي الذي يكونُ في آخِرِ الزّمان.
فالتفضيلِ الخاص للمُعَيَّنين؛ هذا إنّما يُؤخَذ من جِهَة الرّب–تبارك وتعالى- ومن جِهَة الوحي، أمّا ما بَقِيَ بينَ يدي النّاس من أسباب الفَضْل: فإنّما هو الأقوال والأعمال والإعتقادات التي جاءت في الكتاب والسنّة التي هي من صِفاتِ المؤمين، التي من تَحلّى بها واتَّصَف وقامَ بها؛ سواءٌ كانت من العبادات أو الإعتقادات أو الأخلاق أو غيرِ ذلك، فإنّه ينالُ من الفَضْلِ بحَسَبِ ما قامَ بِهِ من هذهِ الفضيلة.
إذًا فأسباب الفَضْل حُصِرَت، وهذا مهم جِدًّا؛ ولذلك كان في زمن السّلف الصالح هذا الأمر معروف؛ أنَّ أسباب الفَضْل التي هي الأوصاف أو الأعيان معروفة عندهم؛ ولذلك روى ابن أبي حاتم –رحمه الله تعالى- في مناقِب الشّافعي، عن أبيه، عن عمرو بن سُواد: أنّهُ سَمِعَ الشافعي–رحمه الله تعالى- يقول، يقول –رحمه الله تعالى-:"ما أعطى الله نبيًّا ما أعطى محمدًا"، فسمِعَ هذا الرجل كلمةَ الشافعي، فاسْتَحْضَرَ شيئًا أوتيهِ بعضَ أنبياءِ الله –جل وعلا- لم يُعْطَى نبيّنا –صلى الله عليه وسلم-، فقال مُسْتَدْرِكًا على الشافعي قال: "أعطى الله عيسى إحياء الموتى ولم يُعْطِهِ النبي –صلى الله عليه وسلم-"، فهذا يدُلُّكَ على ماذا؟ على أنَّ أسباب الفَضْلِ عندَهُم محصورة ومعلومة، ولابدَّ من الإستدلال عليها، فقال له الشافعي: "أعطى الله محمدًا حَنينَ الجِذْع حتى سُمِعَ صوتُهُ، وذلك أكبَرُ من ذلك".
وهذا استنباطٌ عظيمٌ دقيق من الإمام الشَّافعي، أنَّ الميت الذي من شأنه أن يموت ويحيا إذا اُحيِّي؛ فيكون إرجاع له لصفةٍ كانت فيه سابقة، لكن لما يكونُ جمادًا ويُشير إلى قصة الجذع الذي كان يخطبُ عليه النبيَّ-صلى الله عليه وسلم-، وكان هناك امرأةً من الأنصار كما في مسلم، وكان عندها نجَّارًا فعَمِدَت إلى شجر الغابة، ثمَّ صنعت منبرًا من ثلاث درجات للنبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يكون أرفقُ لصعوده وقيامه حال خُطبته-صلى الله عليه وآله وسلم-، فصنعت هذا المنبر وكان هذا الجذع؛ جذع النَّخل هذا قد اعتاد أنَّ النبيَّ-صلى الله عليه وسلم- يقرُبُ منه، وأنَّ النبيَّ-صلى الله عليه وسلم- يخطُبُ عليه، فلمّا انْزَوى النبيَّ-صلى الله عليه وسلم- عنه ورقى على المنبر؛ حنَّ هذا الجذعُ إلى النبيُّ-صلى الله عليه وسلم- وليس من شأنه الحياة حتى سُمع له صوت كصوت الناقة تبكي.
-إذنًا: فهذا الحنين في الجذعِ أبلغُ من إحياء من كان شأنه وهذا يدُلُّك على ما سبق ذكره من أنَّه من أراد تفضيل مُعيَّن، أو أراد تفضيل شيءٍ معين؛ فليأتي عليه بحُجَّة ودليل من كلام الله أو كلام النبيَّ-صلى الله عليه وسلم-.
ولذلك قال الإمام الشافعي–رحمه الله تعالى- عن بعضِ من طرأ في تلك الأزمنة، بأنَّ أهل البدع كما أنّهم يتلاعبون في الألفاظ بزُخرف القول؛ كذلك يتلاعبون في الأوصاف فيضفون على من أرادوا تعظيمه أنواعاً من الأكاذيب وهالاتٍ من التقديس يَغُرُّونَ بها السُّذَّج والنَّاس، ولذلك قال الشافعي عن بعضهم :" لو طار في الهواء أو مشى على الماء لا نقبل منه إلا أن يأتينا بشاهدَيّ عدل من كتاب الله وسُنَّة النبيَّ-صلى الله عليه وسلم-" .
فمعرفة أسباب الفضل والتفضيل من الفقْهِ في الدّين المهم الذي إذا وُفِّق إليه العبد؛ فيكون في حَصَان وفي حِماية من أن يَنْطليَّ عليه مقاييس، أو موازيين ليست شرعّية ،كما أنّه يصيرُ إلى معرفة الموازيين الحقَّة التي توزنُ فيها الأقوال والأعمال والأشخاص .
ولذلك قيل أنَّ رجُلاً من كبار المتكلمين وأئمتهم، دخل بغداد فتَجمهَر النَاس عليه أيُّ تجمهُر، تجمهر النَّاس على هذا المتكلم الكبير فإذا بعجوز تسأل، تقول: "مال الناس متجمهرين ؟ قالوا : هذا رجلٌ يعرفُ ألف دليلٍ على وجود الله، فقالت ما معناه تباً له وهل الله-عزَّ وجل- يحتاج إلى كل هذا حتى يُعرف وجوده".
فانظر إلى هذه العجوز الساذجة التي هيَّ على الفطرة إذا صحَّ التعبير لما اعتصمت بالحق وبموازينه مع وجود كل هذا البهرج والجمهور؛ احتقرت الأمر ورأت أنه ليس بشيء.
إنَّ معرفة الموازيين الحقة، وأسباب التفضيل وأنها محصورةٌ فيما يأتي عن الله –جلَّ وعلا- من العلم النَّافع الذي يجبُ على طالب العلم أن يحرص عليه وأن يعتصم به، لا يغُرَّنك حفظُ حافظ ولا يغُرَّنك فصاحةُ مُتكلم ولا يغُرَّنك عبادة، بل لماذا نذهب بعيدًا وبين يدينا مثال نعلمه جميعاً؛ فنحن نعلم مثلاً أنّ بعض أصحاب النبيَّ-صلى الله عليه وآله وسلم- قد بُليَّ بشُربِ الخمر، حتى أنّه كان كما في البُخاري يؤتى به كُلَّ مرة شارباً للخمر والخمرُ أمُّ الخبائث كما قال-صلى الله عليه وآله وسلم-: (( فقال رجلٌ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال : لا تلعنه إنه يُحب الله ورسوله))، أثبت النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- لِمنْ يشربُ الخمر أخصُّ صِفاتِ الإيمان! وأعظمُ شُعَبْ الإحسان؛ حُبُّ الله-جلّ وعلا-، بينما الخوارج؛ النبيُّ- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصِفُهُم بالعبادةِ الكثيرةِ الشّديدة، وكثرةِ قِرائتِهم للقُرآن، وكثرةُ عِبادتِهم وكثرةُ زُهدِهم وكثرةْ؛ ثمّ يصِفُهُم بأنّهُم يمرُقونَ من الدّينِ كما يمرُقُ السهمُ من الرميّة! بل يأمُرُ بقِتالِهم!!!
هل يوجدُ أوضَحَ من ذلك في أسباب الفضْل؟!
ولذلك لما قيلَ للإمامِ أحمد-رحمه الله تعالى-؛ الرّجُل يُصليّ ويصوم ويقوم الليل خير؛ أمْ يرُدّ على أهل البِدع؟
قال:" لا، إن صام وصلّى فذلك لنفسِهِ، والردّ على أهل البِدع فذلك أعمُّ بالنفع" (وكما قال) -رحمه الله-، انظُرْ إلى ميزان هذا الإمام!
ونحنُ في هذه الأزمِنة؛ ما أحوَجَنا إلى تحريرِ وتحقيقِ موازينِ السّلفِ الّصالح، لأنّ النّفوس مع الغفلة تُغَرُّ وتُخْدَع، حسبُك الأحاديث الّصريحة الّصحيحة؛ التي ذكرها الرسولُ- صلى الله عليه وسلم- في وَصْفِ الخوارج، ومِن تَقْبيحِ ما هُم عليه، ومِن شدّةِ التّحذيرِ منهُم، ومع هذا؛ حين لَقيَهُم بعضُ أصْحابِ النبيّ-صلى الله عليه وسلم-وقف شعْرُهُ ! لأنّهُ رأى القُرآءْ العُبّاد.
فالمقصود: لا يأمننّ إنسانٌ على نفسِهِ! يقولُ عرفتُ الحقّ في وقتٍ ما؛ أو في لحظةِ ما؛ أو في يومٍ ما؛ أو في سنةٍ ما، فالحقُّ مؤْنَتُهُ الجِهاد في سبيل الله؛ والإعتصامِ به ما حَييت، إذا كُنت تُريدُ أن تكونَ على السنّةِ الخالصة؛ في هذه الأزمِنة التي كَثُرَ فيها الممثِّلون، والمتَفَيهِقون، والدّجَّالون، والخدّاعون، أنواعٌ من التَمثيل، وأنواعٌ من الأشياء التي تَغُرُّ الجاهِلين، فنحنُ في زمن؛ ما أحوجنا إلى أن نعلم وأن نعرِف أسباب التّفضيل.
بل من عجيبِ هذه المسألة: أنّ الإمام ابن القيّم-رحمه الله تعالى- حين ذكرَ؛ مداخِل الشّيطانِ على الإنسانِ (نعوذُ بالله من همزات ونزغات الشياطين)، لما ذكر مداخِل الشيطان على الإنسان؛ ذكر مراتبَ ستّة، يأتي فيها الشيطان للإنسانِ يُغويهِ، ويستدرِجَه حتى يُوقِعَهُ في تَلابيبِه، فذكر آخِرها: أنّه إذا عجز منهُ من خمسِ مراتب؛ تبتدِئُ بالشرك، ثمّ بالبِدع، ثمّ بالفواحِش، ثمّ بالتّوسُعِ في المُباح، ثمّ بالمكروهات، ثمّ يأتِيهِ إلى مرتبةِ (ماذا؟)؛ أنّهُ إذا كان عَملين: أحدُهما أفضلُ مِنَ الآخرِ في حقِّهِ؛ فيُشغِلُهُ بما هوَ مفضول، حتى ينال حظّهُ منه.
فالمقصود: إنّ معرفةَ الفضل؛ وأنّهُ محصورٌ بما يأتي عنِ الله- جلّ وعلا- مسألة مُهمّة، والخديعةُ فيها وارِدةٌ على كلِّ نفس إلاّ أنْ يشاء الله- تبارك وتعالى-، فإذًا، التّفضيل والفضل: إنّما يُؤخذُ من جِهةِ الله- سبحانه وتعالى-؛ وطبعًا من جِهةِ نبيّه- صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
-المسألة الثانية: مسألةُ الإضافة، طبعًا مسألة الإضافة المقصودُ بها ماذا؟
ما يُضافُ إلى الله- جلّ وعلا-؛ يعني ما يُنسَبُ إلى الله- جلّ وعلا-، ما يُنْسَبُ إلى الله-جلّ وعلا-، يعني ما يُطْلَق على الله-جل وعلا-من الألفاظ تُنْسَبُ إليه-سبحانه وتعالى-، فهذه الإضافة المضافات إلى الله-جلّ وعلا- تنقسم إلى قسمين:
1-إضافةُ صفات
2-وإضافةُ أعيان
-إضافة صفات ومعاني، وإضافة أعيان مخلوقة، ما الفرق بينهما؟
-إضافةُ الصفات: هي أن يُضَاف لله-جلّ وعلا- معنىً لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، مثل القدرة، العلم، الإرادة، فمثل هذه المضافات إذا أُضِيفت إلى الله؛ علمُ الله، قُدْرةُ الله، إرادةُ الله-، فهذه ليس لها قيامٌ بنفسها، يعني ليست مخلوقة وليست هي قائمة بغيرها من المخلوقات، إذنًا يجبُ أن تكون هنا صفةٌ لله-جلّ وعلا- على ما يليقُ به-سبحانه-، ويمتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق إلى الله-سبحانه وتعالى-.
-القسم الثاني الذي هو إضافة الأعيان المخلوقة: فهو أن يُضَاف إلى الله-جلّ وعلا- ما يقوم بنفسه، ما يكونُ عَين قائمة بنفسها.
فهنا إذا كان شيئًا قائمًا بنفسه مخلوقًا فإذا أَضِيفَ إلى الله-جلّ وعلا-؛ فلا تكون إضافته إلى الله-عزّ وجل-إضافة صفة لله-سبحانه وتعالى-، إنّما تكون إضافةً بحَسَبِها-كما سيأتي بيانه إن شاء الله-.
فهنا إذًا ناقةُ الله، بيتُ الله، عبدُالله، هنا هذه كلها مخلوقات أُضِيفت لله-تبارك وتعالى-، فمثلًا قولُ الله-جلّ وعلا: }وَلَا يُحِيطُونَ بِشَئٍ مِنْ عِلْمِهِ إلّا بِمَا شَاء{ ]البقرة:255[، علمُ الله، علم شئ مخلوق قائم بذاته؟
لا هذا وصف، فأُضِيفَ إلى الله فتعيَّن أنْ يكون صفةً لله-جلّ وعلا-وامتنع أن يكون مخلوقًا.
}إِنَّ اللهَ هُوَ الرَزَّاقِ ذُو القُوَّةِ المَتِينِ { ]الذاريات:58[، ذو القوة: القوة هذه عينٌ قائمة بنفسها؟ لا، إذًا فتعيَّن أن تكون صفة لله-جلّ وعلا-، أي الله-جلّ وعلا- موصوف بالقوة.
مثلًا قولُ النبيّ-صلى الله عليه وسلم: ((اللهم إني استخيرُكَ بعلمك واستقدِرُكَ بقُدْرَتِكَ وأسألُكَ مِن فَضْلك))، علمك قُدْرتك فضلك: علمُ الله هنا هذا ليست عَين قائمة بنفسها وليست قائمة بغيرها من المخلوقات، إذًا فوجب أن يكون صفةً لله-جل وعلا-، كذلك قدرته-تبارك وتعالى-، كذلك فضله-سبحانه وتعالى-.
فهذه أوصاف لله-جلّ وعلا-، لكن لما تأتي مثلًا إلى إضافة الأعيان؛ يعني قول الله-تبارك وتعالى: }وَطَهِّرْ بَيتِيَ لِلطَائِفِينَ{ ]الحج:26[، بيتُ الله-جلّ وعلا- موجودٌ مخلوق عين قائمة بذاتها موجودة، ما دام أنّها عين قائمة بذاتها موجودة إذًا فيتعيّن أن يكون إضافتهُ لله-جلّ وعلا-ليست إضافة صفة لله-عزّ وجل-، بل هو مخلوق مربوب لله-تبارك وتعالى-.
قول الله-جلّ وعلا- مثلًا: }نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا{ ]الشمس:13[، ناقةُ الله: الناقة مخلوقة موجودة مُبْصَرة معروفة قائمة بذاتها، فهنا يتعيّن ألاّ تكون صفة لله-تبارك وتعالى-، لكنّها أُضيفت لله إضافة الخلق والربوبية والملك لله-سبحانهُ وتعالى-.
وهكذا في أمثلة كثيرة، ولكن مثل قول الله-جلَّ وعلا-:{عَيْنًا يَشْرَبُ بِا عِبَادُ اللَّهِ} [ الإنسان 6]، يوم القيامة يُكرمهم اللهُ-جلَّ وعلا-فعباد اللهِ هنا: عباد الله الذين عبدوه في الدنيا معروفين: الأتقياء، الأنقياء الذين عبدوا الله يُكرمهم اللهُ-جلَّ وعلا-، إذًا فهم أعيانٌ قائمينَ بأنفُسهم فيمتنع أن يكونَ إضافتهم-لله جلَّ وعلا-إضافة الصفة، إنّما إضافتهم لله-سبحانه وتعالى- هي إضافةُ التشريف والتكريم لهم.
المضافات للهِ- عزَّ وجلّ-: ما يُضاف للهِ- تباركَ وتعالى-من الأعيان يُضاف إلى الله- عزَ وجلّ- على وجهين:
ما يُضاف إلى اللهِ-سبحانه وتعالى-من الأعيان المخلوقة التي إضافتها لهُ ليست صفةً لله- عزَّ وجلّ-، إنمّا هي إضافةُ مُلك وخلق أي أنها مخلوقة، مربوبة للهِ-سبحانه وتعالى-، فهذه الإضافة؛ إضافة هذه الأعيان تنقسم إلى قسمين:
-إضافة عامة، أي أنَّ كُل المخلوقات هم مُضافينَ إلى اللهِ- جلَّ وعلا- من جهةِ ماذا ؟
خلق الله عزَّ وجلّ- كما قال اللهُ- تباركَ وتعالى-:{هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ }[ لقمان 11 ]، فإذًا {خَلْقُ اللَّهِ}هنا الكُلّ، كلّ المخلوقات داخلينَ في ربوبية الله- عزَّ وجل- وملكهِ وخلقهِ وتقديره-سبحانه وتعالى-.
-القسم الثاني؛ وهو ما يُضافُ إلى اللهِ -جلَّ وعلا- لإظهارِ فضلهِ، وإظهارِ تشريفهِ، وإظهارِ إكرامهِ واصطفائهِ، إمّا لأنّهُ آية من آيات الله- تباركَ وتعالى- (كناقةِ الله)، فناقةُ الله- جلَّ وعلا- من آياتهِ الباهِرة التي خلقها اللهُ-عزَّ وجل- ليست كسائر النُوق، فهي من آيات الله، فإن أُضيفت إلى الله-جلَّ وعلا- تشريفًا وإظهارًا لمزِّيَتِها وفضلها على سائِرِ النياق.
(بيتُ الله)، بيتُ الله العتيق، لماذا يُضاف إلى الله- عزَّ وجلّ-؟
لأنّهُ موضعُ الذي فيهِ من العبادات ما لا يوجدُ إلا فيه، والذي لهُ من الفضلِ عند الله- عزَّ وجلّ- ما لهُ، إذًا فهذه الإضافة؛ إضافةُ تشريف، إضافةُ تفضيل، إضافةُ إكرام.
(مساجِدُ الله) التي يُطاعُ اللهُ جلَّ وعلا- فيها، ويُقرأ فيها القرآن، ويُمتنعُ فيها من فضول المباح، وتتركُ فيها بل يُمنعُ ويَحرمُ فيها أنواع من المباحات، فهذه تُضافُ إلى الله – جلَّ وعلا- لشرفها وتفضيل من اللهِ- جلَّ وعلا- لها.
كذلك كما ذكرنا في المثال مثلًا {عِبَادُ اللَّهِ{، فنحن نعلم أنّ كُلّ من في السموات والأرض إِلَّا آتِ الرَّحْمَن عَبْدًا، لكن لمْ يأتيه عبد داخِل في عبوديته من جهة الربوبية، وأنّهُ مُلكُ الله وأنهُ خلقُ الله، هل يستوي هو ومن أختار أن يعبد الله ؟! {ولَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ } [ الجن 19]، لما قالها الله- جلَّ وعلا-في حقِّ نبينا-صلى اللهُ عليهِ وآله وسلم-:{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ}[الإسراء 1 ]، لا، هنا تشريف للنبيّ- صلى الله عليه وسلم- ووصفه وإكرام لهُ، وإظهار لفضلهِ-صلى الله عليه وسلم-.
كذلك ما يتعلقُ في أصل المسألة التي جاءت في الكتاب: وهو مسألة الروح، ونسبة هذه الروح لله-سبحانهُ وتعالى-، فالروح طبعًا ذُكِرَت مع مريم-عليها السلام-، وذُكرت كما هنا من جهةِ آدم-عليهِ الصلاة والسلام-.
ذكر الله –جل وعلا- أنّ الروح؛ أنّه نفخ في مريم من روحنا وهذا في مواضع من الكتاب العزيز كما قال الله –جل وعلا-: }وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾ { كما في سورة الأنبياء، وفي سورة التحريم قال الله–جل وعلا-: } وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴿١٢﴾{، هناك قال: (فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا)، وفي التحريم قال: (فَنَفَخْنَا فِيهِ)، فنفخنا فيها أي في المرأة؛ في مريم، من روحنا فنفخنا فيه: أي في فرجها من روحنا، لكن هذا النفخ من هذه الروح وضح الله –جل وعلا- حقيقتها، كما قال الله –عز وجل-في سورة مريم:} فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا{.
فتبيّن إذًا: أنّ هذه الروح؛ روحٌ مخلوقة لله–تبارك وتعالى-، لكن تخصِيصُها بالذكر ونِسبَتُها إلى الله (روحنا) تشريفٌ، وتكريمٌ لهذه الروح المقدسة العظيمة. إذًا فنسبة الروح إلى الله –جل وعلا- لا يُقْصَدُ بها أنّها الخالق، ولا أنهّا صفة الخالق–تبارك وتعالى-، لكنّها روح مربوبةٌ مملوكةٌ مخلوقةٌ لله–جل وعلا-، لكنّها خصت بفضل، فنَسَبها الله –جل وعلا- إليه –تبارك وتعالى-. وأكثر أهل العلم على أنّ هذه الروح هو جبريل–عليه السلام-.
إذًا فالروح هنا يَقصد بها الروح المخلوقة، فنفخنا فيها من روحنا ونفخنا فيه من روحنا أي: من روح المخلوقة لله –تبارك وتعالى-.
طيب، أيضًا آدم–عليه الصلاة والسلام- قال الله –جل وعلا-:} فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾{، هي نفس الروح؛ أيضًا روح مخلوقة لله–تبارك وتعالى- نفخ الله –جلّ وعلا-، نفخت في مريم نسبَ الله-جلّ وعلا-؛ ما الفرق ؟
-الفرق؛ أنّه في قصة مريم نُسِبَ النفخ إلى هذه الروح فنفخنا فيها من روحنا، في قصة آدم –عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث معنا هنا: (( ونفخ فيك من روحه )) قال الإمام: "فالمنفوخ منه الروح المضافة إلى الله إضافة تخصيص وتشريف، والله هو الذي نفخ".
إذًا نسب الله –جل وعلا- النفخ إلى نفسه تشريفًا لآدم، ولذلك قال الله –جل وعلا- :
}فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾{، فرتب الأمر بالسجود لآدم على هذا النفخ، لما فيه من التشريف والتفضيل لآدم–عليه الصلاة والسلام-.
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : " فعلق السجود بأن ينفُخ فيه من روحه، فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذي ليس لإبليس مثله".
إذًا فالروح التي نُفِخ فيها هي روح مخلوقة، مقدسةٌ شريفة، خصّها الله-جلّ وعلا- بهذا الفارق بين مريم وبين آدم–عليه الصلاة والسلام-.
إذًا: فتبيّن لنا أنّ ما يضاف إلى الله–جل وعلا- ننظرُ فيه؛ فإن رأيناهُ صفةً غير قائمةٍ بنفسها أو بغيرها من المخلوقات؛ علمنا أنّ هذه الإضافة؛ إضافة وصف لله –تبارك وتعالى-، كما قال الله –سبحانه وتعالى- مثلًا:}أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي{ [طه:93]، أمر قائم بنفسه؟ ليس قائمًا بنفسه، والله –جلّ وعلا- أنكر عصيان أمره، فدلّ على أنّ المراد: أمره الذي هو كلامه الذي هو صفته –تبارك وتعالى-، قال الله –جلّ وعلا-:}ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّـهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ{ [الطلاق:5]، إذًا فهذا كلامهُ، أمرهُ الشّرعي، الوحي الذي رَضيه دينًا، فهذا صفةٌ للهِ–تبارك وتعالى-، خلافًا لقولِ الله–جل وعلا-مثلًا:}وَكَانَ أَمْرُ اللَّـهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا{[الأحزاب:38]، أمر الله هنا:
المقصود ما يقعُ بأمره، أي مفعولهُ –سبحانه وتعالى- أي مخلوقُهُ، أيضًا مثل ذلك قول الله–جل وعلا-:}أَتَىٰ أَمْرُ اللَّـهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ{[النحل:1]، أمره أي؛ ما وقع مما أخبر به مما سيجري، فهذا مخلوق لله-سبحانه وتعالى-، وذلك أنّ العرب في لسانها تُطلِقُ اسم الصفة على المفعول بها؛ لأنّهُ من أثرها، وهذا الذي يسميه النحاة ماذا؟ مصدرًا، يسميه النحاة إيش؟
مصدر: ذو القدرة الله، هذا معروف عند العرب، تقول العرب مثلاً: هذا الدرهم، هذا الدرهم ضَربُ الأمير، ضرب الأمير يعني إيش؟ ضرب مصدر، اسم صفة، ضرب الأمير يعني مضروبُهُ وقع عليه ضرب الأمير مفعوله، إذًا فهذا من تتمت البحث هنا؛ وحسن فهم هذا يجعلك تُحْكِم هذا الباب كُلُهُ.
إذًا فالعربُ تُطْلق المصدر على الصفة وعلى ما يقع في الصفة، هذا من استعمال العرب، والقرآن بلسان عربي مبين، إذًا }أَتَىٰ أَمْرُ اللَّـهِ{ هنا مخلوق لله–جل وعلا- لكن أضيف إلى الله لما فيه من باهِرِ قدرة الله–جل وعلا-،}وَكَانَ أَمْرُ اللَّـهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا{.
مثلًا قول الله–تبارك وتعالى-:}وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{ [الأنعام:115]، }وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ{ هنا كلمة ربك ماذا؟
كلمة ربك التي هي صفته–تبارك وتعالى-، كلمة ربك هنا، لماذا؟
لأنّها ليست عين قائمة بنفسها، ولا يتصف بها مخلوق ونسبت إلى الله فما المانع أن تكون كلام الله –جل وعلا- على ما يليق بالله –عز وجل-؟!
}وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّـهِ{ [التوبة:6]، كلام الله هنا ماذا؟ كلامه الذي تكلم به–سبحانه وتعالى- الذي هو القرآن الكريم، إذنًا لكن لما أطلق الله –جل وعلا- لفظ الكلمة على عيسى بن مريم–عليه الصلاة والسلام-:}إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّـهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ{ [النساء:117]، فهنا لما أطلق على عيسى كلمة، عيسى كلمة؟ أنت تراه كلمة؟ هل فيه معنى الكلمة؟
هو مخلوق، قائم عين قائمةٌ بنفسها، لكن لما خُلِقَ بالكلمةِ الله-جلّ وعلا-على خلاف ما خُلِقَ سائر البشر والآدميين، لأنّ الآدميون يخلقون من أم وآب، أمّا عيسى-عليه الصلاة والسلام- خُلِق من أمٍّ فقط، ثمّ خُلِق بكلمة الله فأُطلِق عليه كلمةِ الله تشريفًا له، وإكرامًا له من الله–جلّ وعلا-، وإلاّ فهو مخلُوقٌ من مخلوقاتِ الله-تبارك وتعالى-، طبعًا أهمية هذا البحث تأتي من أين؟
تأتي من جهة أنّك إذا عرفت أو علمت أنّ توحيد الله-تبارك وتعالى- معناه؛ حقيقةُ معنى التوحيد: الفرق بين الخالِقِ والمخلُوق، التوحيد أن تفرِّق بين الخالق والمخلوق فيما يستحقُّه الخالق من الوصفِ وما يختَّصُ به من الحقّ، فهذا التفريق هو التوحيد لله–عزّ وجل-.
أن تعرف الله–جلّ وعلا- كما وصف نفسه–سبحانه وتعالى-، ثمّ أن تعطي الله–جل وعلا- حقَّهُ المختصُ به، فهنا تكون ماذا ؟
قد وحَدّت الله–جلّ وعلا-.
بينما الشّرك بالله–جلّ وعلا- على النقيض، ما هو الشرك ؟
الشرك إذا أردت أن تعلم جِماَعَ معنى الشرك فهو:
إمّا تشبيه خَالقِ بالمخلُوق، أو تشبيه المخْلُوق بالخالِق، فهذا هو الشرك بالله–جلّ وعلا-. فإذا سلبت أو نفيت عن الله–جلّ وعلا- ما وصف به نفسه من الكمال؛ فهنا إنتقصته، فهنا أشركت، لأنّك لما انتقصتُه شَبهته بالمخلوق، كذالك حين تأتي إلى المخلُوق فتصِفُه بصِفة الخالِق فهنا تكون أيضًا قد أشركت بالله–عزّ وجل- عياذًا بالله.
إذًا؛ فهذه المسألة توضح لك تمام الفرق بين الخالِق والمخلوق، وإذا علمت أنّ عامّة الأمم ممّن بُعِث فيهم الأنبياء، ومنهم هذه الأمّة قد وقفوا على طَرفَي نَقِيض من مثل هذه المسألة، فقوم ٌكلّ ما يُضاف إلى الله–جل وعلا- يصفونه بأنّه مخلوقٌ من مخلوقاتِ الله-تبارك وتعالى-، فقدرة الله مخلوقةٌ عندهم، محبة الله مخلوقة عندهم، إرادة الله مخلوقة، كلام الله مخلوقة، وهكذا، وهؤلاء هم المعطِّلة وهم درجات من التجهُّم إلى ما دونه، فهؤلاء يعطِّلون الله–جلّ وعلا-
كلّ ما يُنْسَب إلى الله–عزّ وجل- لا يجعلونه وصفًا لله، فلا يثبتون لله محبةً ولا إرادةً ولا كلامًا ولا علمًا، ثمّ هم بعد ذلك متفاوتون، يقابلهم من يجعل كل ما نُسِبَ إلى الله من صفة الله، فروح الله هنا ماذا يجعلونها ؟
يجعلونها صفة لله ويزعُمون أنّ الإنسان فيه من الله، وهذا موجود في هذه الأمّة، وكثير، وهم من ؟
الصوفية، سواءٌ كانوا أهل وِحدة، أو أهل إتحاد، أو أهل حُلول، فهؤلاء المتشبِّهون بماذا؟ بالنصارى، وهذا موجود ومع الأسف.
سمعت قبل وقت غير بعيد، لما أُعطَيت شريط في مجمع للنّساء يوزع فيه لرجلٍ يشرح فيه أسماء الله –جلّ وعلا-، فسمعت طرفًا فإذا به من خلال شرحه لأسماء الله يدُسُّ مثل اعتقادات الصوفية هذه، وهو أن يجعل الإنسان؛ لا أنّه يوحِّدُ الله تعظيمًا لأنّ أهل السنّة يوحدون الله ماذا ؟ تعظيمًا بكمال محبته وكمال الذلِّ له، وبإخلاص الدّين له– جلّ وعلا-، يوحدونه بماذا؟ بعبادته والاستعانة به.
أمّا الصوفية فيوحدونه مِن جهةِ الربوبيّة، حتى لا يرون فرقًا بين الخالق والمخلوق!
فمن خلال شرحه لأسماء الله يُوصِلُ النّاس إلى أن يُوقِع في قلوبهم مثل هذه المعاني الخبيثة، التي تخدش في توحيد الله-تبارك وتعالى-، فإذا لم يكن المسلم على حَصَان؛ وعلى معرفه باعتقاد الحقّ في الربِّ-جل وعلا- وباعتقاد أهل السّنة، فكم يكون عرضةً لأباطيل، وشرور عظيمة متلاطمة.
إذًا: فالصحابه-رضوان الله عليهم-، وتابعوهم بإحسان، وأئمة السنّة والعلم، كالأئمة الأربعة -رحمهم الله-وغيرهم، كلّهم مُستّقرٌ عندهم بوضوح التفريق بين مخلوقات الله-جلّ وعلا- وبين صفاته، فيعرفون أنّ العِباد مخلوقون، مربوبون، مقهورون، وأنّ صفاتهم تابعةً لذلك، ويعلمون أنّ الله-جل وعلا- صفاته على ما يليق به-سبحانه وتعالى-، فينزهون الله، ويقدسونه، ويعظمونه، ويوحدونه-تبارك وتعالى- بإثبات صفاته له -جلّ وعلا- من غير تشبيه، ولا تعطيل، ولا تمثيل، يثبتون لله-عزّ وجل- ما اختّص به من الصّفات، ويعتقدون أنّ الله -جلّ وعلا-لم يزل ولا يزال بصفاته-تبارك وتعالى- كما يليق به، وينفون عنه النقائِص، وينفون عنه مماثلة المخلوقات، ويجرون على ما جرى عليه أنبياء الله-تبارك وتعالى- في هذا الباب العظيم، فيثبتون لله-تبارك وتعالى- كلّ صفة كمال، ويثبتون له- تبارك وتعالى- كلّ إكرام وجلال-سبحانه وتعالى-.
فهذه المسألة وشبهها مسائل ينبغي لنا، ولكل عبد مسلم ومسلمة أن يسأل الله-تبارك وتعالى-أن يجعل معناه الحقّ واقرًا في قلبه، وأن يجعلها راسخةً في إيمانه، حتى يعرف ربه وإلهه الحقّ، فيعبده، ويُنيب إليه، ويخلص الدين له-تبارك وتعالى-.
(ما في بأس أن أختم بشيء حقيقة بوديّ أن أختم به هنا ؟)
أثناء نظري في بعض كتب التفاسير، وقع في ذهني، أن ألقي نظرة في كتاب [في ظلال القرآن] لسيد قطب، قلت: ما الذي سيقولهُ هنا ؟! فطبعًا لمّا رجعت إليه وجدت بعض كلامه، يقول مثلا:"إنّ طبيعة الإنسان قد دخل فيها عنصر جديد هو النفخةُ من روح الله !"
ويقول:"ونفخهُ فيه من روحهِ المشِرِطِ الكريم"، طبعا ما يذكر في أي موضِع؛ ما هذه الروح وأنّها مخلوقه، كما يذكر في كتب التفسير، وعن أهل العلم، ويقول:"ولا كيف تلبست نفخة الله الأزلي الباقي بالصلصال المخلوق الفاني"، ويقول: عند قول الله-جل وعلا-:}فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي}]الحجر:29[، قال: "فهي روح الله تنقلُ هذا التكوين العضوي الوضيع إلى ذلك الأفق الإنسانيّ الكريم منذ بدء التكوين، وتجعله ذلك الخلق المتفرد، الذي تُوكَلُ إليه الخلافة في الأرض بحكم تفرّد خصائصه منذ بدء التكوين، إلى أن يقول هذه النفحة التي".(لأنّي ما أردت أنقل لكم هذا بعدين يقولون أخرجت من السياق وكذا، تعرفون اليوم يعني دَيدَنُ أهل الأهواء أنواع من الخداع.
المقصود إلى أن يقول:" هذه النفخة التي تصله بالملأ الأعلى وتجعله أهلًا للإتصال بالله!!!".
"وتجعلهُ أهلًا للإتصالِ بالله (عياذًا بالله) وللتلقيّ عنه!!!!"
إلى أن يُكمل باقي كلامه وبحثه، طبعًا مع العلم أنه تطرق إلى مسألة النُشوء والأرتقاء ودارون، وطبعًا هذا يعني مجالاتهم هؤلاء القوم، فهذا يدلُّ على أنّ صِلة سيد بمسألة وحدة الوجود لصيقة، وأنّ مسألة إتصالًا مسألة النِيرفانا ليست كما يزعمون منحصرة في تفسيرهِ لسورة الإخلاص {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} لا، الأمر أعمق في اعتقادهِ في هذه المسألة، ولذلك في هذه المواضع نهى أشد النّهي عن الدخول في أي نوع من التفاصيل، وأراد أن تُبقي المسألة على ما هي عليه، حتى يتسنى له أن يقول مثل هذا الكلام، وأن يبُثَ مثل هذه المعاني المنحرفة.
وهنا قد يقول قائل: لماذا تُكثرونَ من نقد هذا الرجل؟
ولماذا تُركِّزونَ على نقدهِ؟ يعني اليوم يقول لماذا تمتحنوننا بسيد قطب؟
-فنقول: لأنَّ سيد قطب وكتابهُ في ظلال القرآن وكتبهُ الأُخرى؛ تُعتبر هي أهم المصادر المُكونة لمذاهب الجماعات الإسلامية السياسية، ليس في حدود مسألة التكفير والحاكمية فقط لا، بل إنَّ هذا الرجل يُعتبر العمود الفَقري، أحد الأعمدة الفقرية في التكوين لأنّه ماذا ؟
لأنّه أخذ كتب المودودي المُختصرة ثمّ خدمها بتوَسّع وتفنّن وتلوين، فهذا الرجل وكتبه خطرٌ قائم، كما إنَّ كتبهُ ليست كتب علم، فيها علمٌ نافع، وفيها بِدع كبعض الكتب أهل العلم التي تَفْرِضُ نفسها على أهل الإسلام، وتَفْرِضُ نفعها، ككتب مثلًا ابنُ حجر-رحمهُ الله- والنَّووي-رحمهم الله-.
لا كتبهُ ليس فيها علم، بل إنّهُ يقول هو عن نفسهِ: أنّهُ قرأَ التفاسير فرأى أنهُ تحجبهُ التفاسير عن معاني القرآن!!! فَيطَّرِحُ التفاسير ويقول بهواه، ولذلك لما مات الأئمة-رحمهم الله تعالى-، أعني الأئمة الثلاثة: ابن باز وابن عثيمين والألباني-رحمهم الله-؛ نطقَ عبدالرحمن عبدالخالق من إنّهُ منذ نعومة أظفاره- كما في مجلة السمو-وهو يقرأُ لسيد قطب، فهذا يَدُلُك على أثر هذا الرجل، وأثرهُ المصيبة ماذا ؟
أنَّ أثرهُ على من يزعُم السُنة، ويُلبّس على النّاس، يعني ليس أثرهُ فقط على من ينتحل جماعة معينة، لا، أثرهُ حتى على من؟! ولذلك لما كتب بعضهم في التفسير والمفسرون، ثُمَّ عَرَضَ لسيد قُطُب وكتابه في ظلال القرآن، فماذا قالَ حتى يُثبتَ سُنيتهُ أو سَلفيتهُ نقدَ (سيد) من جهة ماذا ؟ من جهة تأويلهِ للصفات، لكنّهُ لم يستطع أن يتمالك نفسهُ فيمدحهُ بماذا ؟
في جانب الدعوة والحركة ! يعني السُم العُضال الذي فتكَ بالنّاس؛ هو من جهة الدعوة والحركة وفقه الواقع وهذه الأشياء الموجودة عند سيد، وهذا يُظْهِر السنّة ويَنْقده من جهة السُنة ويُنكر عليه تأويل الصفات، ثم لا يملك إلاّ أن يمدحه في هذا الجانب، وشيخٌ آخر ظَاهِرُه السُنة،(أنا ما أقول من الجماعات المعروفة ليست من السنّة)، وشيخٌ آخر يحرص على أن يُخفف من وطأةِ ماذا ؟
من وطأةِ كُتُبِ سيد قُطب عند الطلاب، دون أن يُصَرِّح بمدحهِ أو شيء، لكن ماذا يصنع؟ كما حدثني بعضُ إخواننا الثِّقات ممن كان يحضر حِلَقَه، يأتي إلى حِلْقَته ومعه (في ظلال القُرآن)!!! ويقرأ فيه حتى يكسر الحاجز بين الطُلاب وبين هذا الكتاب، وهو مُظهِر للسُنة!.
أما القول: بأن كُتُب سيد قُطب، هي كتب أدبيّة وأساليب!! هذا كلام يعني يقولهُ من لا يعرف كتبه! بل كتبهُ فيها من الدقّةِ في معرفةِ المذاهب والإطلاعِ عليها الشيء الكثير، مما يدلُّ على أنّها ليست كُتُب أدبيّة، إنّما هي كتب مليئة بالمعاني التي يجمع فيها سيد قُطب بين مذهب الصوفية والخوارِج، يجمع سيد قطب إيش؟
بين مذهب الصوفية برقتِهم، وهيامهم، وذِكرهم، وفُيوضَاتهِم، وهذه المعاني التي تغرُّ النّاس الجُهَّال بالإعتقاد الحقّ والإيمان الصحّيح، ثمّ يمزجُ هذا بشيءٍ من الإرتباط بحاكميةِ اللهِ لاحاكمية اللهَ، التي هي تفصيل ما في الكتاب والسنّة، لا، حاكميةَ الله المتعلقة بربوبيته. ولذلك تجد إذا أردتّ أن تعرفَ سيد قُطُب جيدًا، ففتش عمن يُسميه الإسلاميون الذين يسمُّونهم بالإسلامين؛ من يسميهم الإسلامين بالعلمانين أُنظُر مقدار إستشهادهم في كتب سيد قطب، فمن يُسمى بالعلمانين أكثرُ إستشهادًا بسيد قطب من الإٍسلامين، فكيفَ يتأتى أن يكونَ هذا الرجل وكُتُبهُ ومصادرهُ مَوئِلًا لهاتين الطائفتين المارقتين المنحرفتين!
ما يُسمى بالعلمانين على تفصيل، لا نعيده لأنّه معروف في مثل هذا الإطلاق ومسألة الإسلامين، كيف يكون سيد قطب مصدر للجميع ؟ يكون مصدر للجميع لأنَّ فيهِ تقديم إسلام جديد، تقديم إسلام جديد يَرتبطُ بمعنىً صوفيّ، ومعنى إرتباط بحاكمية تتعلق بربوبية الله- عزّ وجلّ- لا بتحكيمِ شريعتهِ كما جرى عليهِ عملُ المٌسلمون.
ولذلك لا يُعلمُ عالِم من علماء أهل السنّة، عُرِضَ عليه شيءٌ من كلام سيد قطب، إلاّ ونَقدَهُ نقدًا لاذعًا وشديدًا، ابن باز-رحمهُ الله-، ابن عثيمين-رحمهُ الله-، الألباني، بل الألباني-رحمهُ الله- قال أنَّ كُتُبهُ (يعني بعد أن قرأَ ما كتب فيه) قال:" أنهُ ظهرَ أنهُ جاهلٌ بالإسلام أصولهُ وفروعه".
إذًا فكل علماء السنّة الذين يطلعَّون على شيءٍ من كلامهِ؛ يُبادرون إلى نقدهِ والإنكار عليه، فما بالُ أقوام وأقوام يحومون في حَماه ويغارون عليه، ثُم يزعمون خادعين للنّاس أنّهم على السُنة! أيُّ سُنة ؟! كُتب سيد قُطب تُناقض أصول السُنة، ولابُد من البراءةِ منها، هذا حكمٌ شرعيٌ واجبٌ وعلامةٌ فارقة بين السُنةِ والبدعة.
فنسألُ الله- تبارك وتعالى- أن يُظهِرَ الحقّ وأن يُعليَّ مناره، وأن يجمع القلوب عليه، وأن ينصرهُ، كما نسألهُ -تبارك وتعالى- أنّ كُلَ من تقمصَّ ثوب السُنة وهو يخونها بشيءٍ من ألوان الخيانات؛ أن يفضحهُ وأن يُظهر عَوَارهُ وأن يُلهِمَ الشبابَ حقيقةَ أمرهِ، فإنَّ البليةَ كل البليةَ اليوم؛ هي من أمثالِ هؤلاءِ المُظهرين للسُنة، الخائنينَ لها.
فنسألُ الله- تبارك وتعالى- أن يُصلِح الأحوال وأن يكفي الشرَّ والفِتن.
فهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.